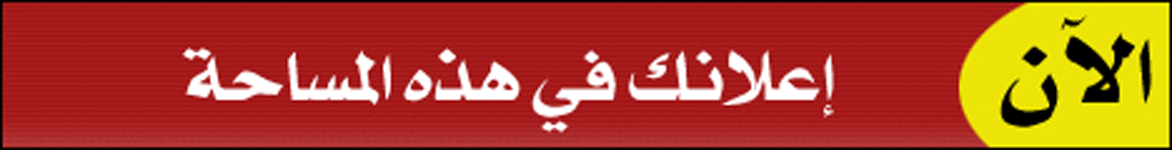في وقت سابق، كانت العلاقات بين الجزائر وفرنسا تجد من يأخذ بها إلى مخرج من المطبات التي تقع فيها بأقل الأضرار… أما منذ بداية العام، فلا يبدو أن هناك استعداداً لدى الطيف السياسي الحاكم في البلدين، للبحث عن أي صيغة لوقف الأزمة بينهما، وهي تكبر مثل كرة ثلج تتدحرج في منحدر شديد الانخفاض.
كتب صحافي جزائري مقيم بفرنسا: «لم تصل العلاقات بين باريس والجزائر إلى حافة القطيعة كما هي الآن. لقد غطيت الجزائر، وما زلت، تحت 6 رؤساء: جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند وإيمانويل ماكرون، و(الراحل) عبد العزيز بوتفليقة وعبد المجيد تبون، وعرفت العديد من السفراء من كلا الجانبين، ولم أرَ قَطّ تصعيداً من هذا النوع. لقد تم قطع جميع الروابط، ولا يبدو لي أن هناك في أي من الجانبين، سبلاً حكيمة للعمل على التهدئة».
وثبت من خلال رد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأحد، على اتهامات جزائرية لمخابرات بلاده بـ«محاولة ضرب استقرارها»، أن الحوار منعدم بين البلدين المتوسطيين الكبيرين؛ إذ قال في مقابلة مع إذاعة «فرنسا أنتر»، إن الاتهامات «لا أساس لها من الصحة وخيالية»، مؤكداً ما نشرته صحف جزائرية بأن الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه، للاحتجاج ضد «ممارسات الأمن الخارجي الفرنسي». وأضاف: «أنا أؤكد هذا الاستدعاء وأعبر عن أسفي له… لقد اتصلت بسفيرنا عبر الهاتف لأؤكد له دعمنا».
وتابع بارو: «في ما يتعلق بعلاقتنا مع الجزائر، قلنا، بل كتبنا حتى في عام 2022، إن الرئيس تبون والرئيس ماكرون وضعا خريطة طريق لتمتين العلاقة بين بلدينا في المستقبل، ونحن نأمل أن تستمر هذه العلاقة، فهذا في مصلحة كل من فرنسا والجزائر»، في إشارة إلى زيارة قادت ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، وتتويجها بـ«وثيقة شراكة متجددة». يومها، قال مراقبون إن العلاقات «في أفضل حالاتها»، خصوصاً أن ماكرون كان قد دان «الجريمة الاستعمارية في الجزائر»، عندما زارها في 2017 وهو مرشح للرئاسة.

وأعلنت عدة وسائل إعلام جزائرية، بما في ذلك الصحيفة الحكومية «المجاهد»، الأحد، أن وزارة الشؤون الخارجية أبلغت السفير روماتيه «رفض السلطات العليا في الجزائر للعديد من الاستفزازات والأعمال العدائية الفرنسية تجاه الجزائر»، مبرزة أن غضب السلطات «ناتج عن الكشف عن تورط أجهزة المخابرات الفرنسية في حملة تجنيد إرهابيين سابقين في الجزائر بهدف زعزعة استقرار البلاد». كما قالت إن الجزائر «تأخذ على باريس احتضانها التنظيمين الإرهابيين: حركة الحكم الذاتي في القبائل، وجماعة رشاد الإسلامية». غير أن هذه الاتهامات غير المعتادة في خطورتها، سبقتها أحداث ومواقف وتصريحات شكلت تراكماً مستمراً حتى وصلت العلاقات بين البلدين إلى القطيعة، آخرها كان احتجاج السلطات الفرنسية على اعتقال الكاتب بوعلام صنصال ومطالبتها الجزائر بـ«الإفراج عنه فوراً». هذا الخطاب رأى فيه الجزائريون «وصاية يريد مستعمر الأمس أن يفرضها علينا».
وقبل «حادثة صنصال»، سحبت الجزائر سفيرها من باريس بعد أن وجّه ماكرون خطاباً إلى تبون نهاية يوليو (تموز) الماضي، يعلمه فيه أنه قرر الاعتراف بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. وعدّت الجزائر ذلك «تفاهماً بين القوى الاستعمارية القديمة والحديثة». وكان هذا «الصدام» كافياً، من جانب الجزائر، لإلغاء زيارة لرئيسها إلى باريس، اتفق الجانبان على إجرائها في خريف هذا العام.

ومنذ بداية 2024 توالت أحداث مهّدت للقطيعة الحالية، كان أقواها سياسياً هجمات مكثفة لليمين الفرنسي التقليدي والمتطرف على «اتفاق 1968» الذي يسيّر الهجرة والإقامة و«لمّ الشمل العائلي» والدراسة والتجارة في فرنسا، بالنسبة للجزائريين. وفي تقدير الجزائر، فقد «بقي ماكرون متفرجاً أمام هذه الهجمات». ومما زاد الطينة بلّة، رفض الحكومة الفرنسية تسليم الجزائر برنس وسيف الأمير عبد القادر، رمز المقاومات الشعبية ضد الاستعمار في القرن الـ19، والذي عاش أسيراً في قصر بوسط فرنسا بين 1848و1852.
أمّا الفرنسيون، فيرون أن ماكرون خطا خطوات إيجابية في اتجاه الاعتراف بالجريمة الاستعمارية، لكنها لم تلقَ التقدير اللازم من جانب الجزائريين، أبرزها الإقرار بتعذيب وقتل عدد من المناضلين على أيدي الشرطة والجيش الاستعماريين، في حين كانت الرواية الرسمية تقول إنهم «انتحروا»، وهو ما زاد من حدّة التباعد بين الطرفين.
المصدر : وكالات