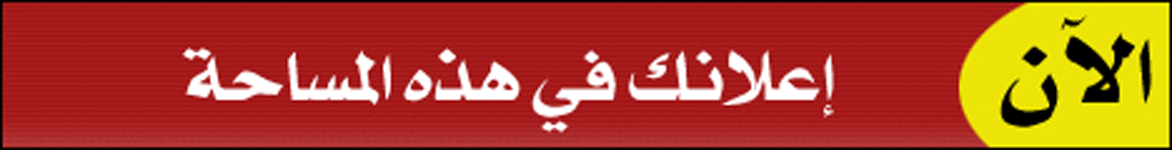في صباي الغرّير كنت أذرّع أزقّة محلات النجف الترابية. وهي التي وصفها ابن بطوطة في رحلته إليها سنة 727هـ – 1326م بقوله: «ليس في هذه المدينة مغرم ولا مكاس ولا آل، إنما يحكم عليهم نقيب أشراف، وأهلها تجّار يسافرون في الأقطار، وهم أهل شجاعةٍ وكرم، ولا يُضام جارهم، صَحِبْتهم في الأسفار فحمدتُ صحبتهم. يجيدون صناعات عديدة، وعلى الخصوص نسيج العباءة (النجفية) بخيوطها الخفيفة، والثقيل الغليظ النسج من الوبر». وقد وصف النجف بأنها من أحسن مدن العراق وأكثرها ناساً وأتقنها بناءً، ولها أسواق حسنة نظيفة.
كما يذكر مؤرخها جعفر باقر مَحبوبة في كتابه الشهير «ماضي النجف وحاضرها»، أنها كانت ميناءً بريّاً توسط العراق ونجد، منذ العصر العباسي، والمغولي، والصفوي الفارسي، والتركي العثماني حتى العصر الحاضر. فيما يؤكد لوي ماسينيون، المستشرق الفرنسي الذي أقام في العراق ردحاً من الزمن وكتب عنه بحوثاً قيمة، في كتابه «خطط الكوفة» أن النجف بلدة بدوية الطبع عربية الطابع، رغم أنها، وهي الملاصقة للكوفة، قامت على أساس الدراسة الدينية مع رحلة الشيخ الطوسي إليها منذ قرون.
يا ترى، هل نجد في وصف ابن بطوطة هذا، وما كُتب بعده مفتاحاً نحو الدخول إلى فهم شخصية المكان النجفي، بمحلاته الأربعة (المشراق، والبراق، والحويش، والعمارة) المكتظة بمبانيها الطينية القديمة، حيث ترعرع محمد مهدي الجواهري، ونشأ بينها، متميزة بدروسها الدينية واللغوية؟ إذ شدَّتني -إذَّاك- قبب زرقاء لمدافن علماء آل كاشف الغطاء وأصهارهم من آل الجواهري. فجدهم الشيخ محمد حسن، مؤلف سفر «جواهر الكلام» الفقهي، انتسبت الأسرة إلى كتابه! هذا الذي أصبح محل اهتمام القانوني المصري الشهير عبد الرزاق السنهوري، حين جاء بغداد الثلاثينات، في مهمة لتنظيم الأحوال الشخصية في العراق الملكي.
الابن المتمرد
في تلك الدروب الضيقة، كنتُ أتحسس خطوات الجواهري، إذ راقتني حيلته الطفولية، مختبئاً في زير ماء معلمه (جناب عالي) هارباً من عقابه القاسي… وقد أصبح الطفل حبيب والده المُعمَّم، الذي حاول أن يورِّثه دراسة العلوم الحوزوية، رغم معرفته بميول ابنه المبكرة إلى قراءة الشعر ونظمه، وقد فرض عليه حفظ آيات من القرآن الكريم وخطب «نهج البلاغة» و«أمالي» أبي علي القالي و«بيان» الجاحظ وتبيانه وأشعار المتنبي.
هذا الميل الباكر هو الذي جعل الابن الضال المتمرد يرتجف، وهو يحمل إبريق الشاي واستكاناته الصغيرة إلى ضيف والده… السيد محمد سعيد الحبوبي، بطل ثورة العشرين، وقبل ذلك الفقيه المعروف، والشاعر رقيق العبارة بموشحاته الراقصة في شعره الغزلي، التي امتاز بها في ديوانه المطبوع في صيدا سنة 1331هـ.
لقد سقط إبريق الشاي النجفي واستكانته من يدي الجواهري، تهيّباً وانبهاراً بشخصية الشاعر، لكي تتفتق موهبة الشعر لديه جزلةً، متناصَّةً مع روائع شعراء العصر العباسي… معجباً بفروسية أبي الطيب، وموسيقية البحتري، وصور أبي تمام، وتفلسف المعري.
بل إن تمكنه من اللغة العربية والشعر القديم، جعله قادراً على «ابتداع» اشتقاقات لغوية في سيميائيته الشعرية. دائماً ما يستوقف النقاد إعجاب الجواهري بواحدة من بداياته الشعرية في ثورة العشرين العراقية:
لعلَّ الذي ولَّى منَ الدهرِ راجعٌ
فلا عيشَ إن لم تَبقَ إلا المطامعُ
غرورٌ يُمنّينا الحياةَ وصفوُها
سرابٌ وجَنّاتُ الأماني بلاقعُ
كان الجواهري قد قرأ دواوين الفحول من شعراء العرب الأقدمين، واستوعب أسرارها الفنية، تسعفه ذاكرة حفظ قوية عجيبة، لم تفارقه وهو في أرذل العمر. ومع ذلك، لم يخضع لضغط قصائدها الفني، بل قام بتفكيكها وإعادة بنائها في شوارده، وفق إحساسه الذاتي ومواقفه السياسية… هذه التي جعلته يكاد يكون الشاعر العراقي، بل الشاعر العربي، الذي عبّر ببلاغته الشعرية البارعة عن مجمل التفاعلات الاجتماعية والأحداث السياسية، التي عصفت بوطنه، منذ نشأته بداية القرن العشرين إلى منتهاه. وقد عاصر ولادة الدولة الوطنية في العراق، حتى تمزُّقه في العقد الأخير من القرن العشرين.
كنتُ حين أطوف بتلك البيوت الطينية العبقة بزهد ساكنيها، بين محلة العمارة ومحلة المشراق -وقد تكرر وقوفي بها طويلاً سنوات غرارة الصبا ويفاعة الشباب- أتساءل: كيف تسنّى للجواهري كتابة مقدمة ديوانه في طبعاته الأولى المعنونة «على قارعة الطريق»، وقد تميزت بنزعة حداثية مبكرة، متسائلة، متفلسفة… مما جعل الشاعر الفلسطيني محمود درويش بعد عقود يعيد نشرها في مجلة «الكرمل» أوائل الثمانينات بوصفها قصيدة نثر؟!
يقول الجواهري وقد عرَّج عليه صاحبه… وهو في منتصف الطريق إلى حيث يريد: أأنت مسافر مثلي؟ قلت: لا! بل أنا شريد. قال: وأين وجهتك؟ قلت: وجهتي أن أضع مطلع الشمس على جبيني، وأغذّ في السير… قال: أوَلك أم؟ قلت: تركتها على قارعة الطريق، وبيدها كتاب، وإبريق، ومبخرة!
وقتذاك كان قد ترك مدينته النجفية وأهلها، لأنه رفض -كما يقول- أن يرقص فيها مثل مَن لم تهب الطبيعة لأحد مثل حيلتها وصبرها على المجاراة… ليكتشف وهو «على قارعة الطريق» كثيراً من الوقائع والحقائق، ذكر بعضها في مذكراته. هل كان لقراءاته في كتب المعاصرين المترجمة -خاصة- دور في صياغة هذا النص النثري المفصلي في حياة الجواهري وتثوير تجربته الشعرية؟ يقول في حوار مع ابنته خيال، إنه كان في التاسعة عشرة من عمره، حين التقط كتب عصر النهضة عبر كتب شبلي شميل وغيره، مما كان يَرِد على النجف من كتب ومجلات عربية بين العشرينات والثلاثينات الميلادية، وكذلك مترجمات لكتب وروايات نقلت أوروبا من قرونها الوسطى إلى العصر الحديث.
دفعته هذه القراءات إلى الخروج المتمرد من قوقعة النجف وسورها الصلد، بقراءاته الواسعة في الأدب الروسي والفرنسي -خاصة- وقد شد الرحال إليها معجباً بحضارتها ومسحوراً بلغتها، ومفتوناً بجمال مَن تعرَّف عليها. واقفاً عند كتابات الفرنسي الغاضب صاحب المقالة الشهيرة «إني أتهم»، إميل زولا، منبهراً بروايته «الأوباش»، التي تمثل فكرتها وعنوانها في واحدة من قصائده الثائرة:
جهِلنا ما يُراد بنا فقُلنا
نواميسٌ يدبِّرها الخفاءُ
فلما أيقَظَتْنا من سُباتٍ
مكائدُ دبَّرتها الأقوياء
وليس هناكَ شكٌ في حياةٍ
تدوسُ العاجزين ولا مِراء
فكانتْ قوَّةٌ أخرى وداءُ
رَجَونا أن يكونَ به الدواء
المعركة مع ساطع الحصري
من هنا تبدأ تجربة الجواهري الشعرية والسياسية، بانتقاله بعمّته وجبّته أواخر العشرينات إلى بغداد، للتدريس في إحدى مدارسها الثانوية. على أثر ذلك، احتدمت المعركة بينه وبين المفكر القومي السوري ساطع الحصري، الذي شكك في جنسية الجواهري ووطنيته. لخَّصها الشاعر بعد ذلك سنة 1968 في بيتيه الساخرين من قصيدته «إيه بيروت»:
أنا -بيروتُ- قطعةٌ من أديمٍ
عربيٌّ دماً ولحماً وجِلداً
أولدُ الضادَ ضيغماً
ودعيّ «ابن تسعين» يمسخ القاف قرداً
لم يستمر الجواهري في رغيد عمله في تشريفات الملك فيصل الأول، رغم احتضانه له بعد هذه المعركة السجال، بل وقف معه رغم ما استثارته قصائد الجواهري، من خروج على العرف الاجتماعي والنمط الثقافي، خصوصاً في قصيدته «جرّبيني» وكذلك «النزعة أو ليلة من ليالي الشباب»، بعدما أطرح عمّته دون مراعاة لأحد، منصاعاً في معظم شعره لتمرده النفسي وجيشانه الشعري وتقلباته الفكرية.
لقد اشتد في اشتطاطه هذا منذ خرج سنة 1930 إلى عالم الصحافة وصخبها السياسي، مصدّراً الجريدة تلو الجريدة، حتى عام الوثبة ومعاهدة بورتسموث سنة 1948. وقد استوى شعر الجواهري على سوقه الغاضب ومزاجه المتقلب، حيث قُتل أخوه الأصغر جعفر… وما أدراك ما أخوه جعفر، رواء الربيع. في لقائي التلفزيوني معه في دمشق في يوليو (تموز) سنة 1994، سألته: كثير من القصائد التي قالها الجواهري غالباً ما تتردد فيها مفردة (الدم)، فهل لمقتل أخيك جعفر دورٌ في ذلك؟ ولماذا لم تستبدل بمصطلح الدم مصطلحاً آخر يحاول أن يؤسس مفاهيم جديدة في العقل والوجدان العربي؟
أجاب: «والله مثلما تفضَّلت، كأنه الآن شخص يُنبّهني كأنني غير منتبه إلى مسألة جعفر. وأنت في الحقيقة الآن ذكَّرتني، فقبلها لم أفكّر بهذا الموضوع. الآن جعلتني أفكر أنَّ لها دخلاً؛ لأنه في هذه اللحظة شَخَصَتْ القصائد أمامي، قصائدي قبل مقتل جعفر وبعدها. فوجدتُ أنك تجد أنت بالذات بنظرة سريعة على المرحلتين قبل وبعد، الفرق كبيراً. الدم ابتدأ يتكرّر عندي كثيراً وأنا أعترف بذلك. في الواقع أنا لا أحب الدم، إلَّا دم الشهيد؛ لأن دم الشهادة ليس قليل الشأن ولا سهلاً، فأن يستشهد المرء أمر صعب، والدم غالٍ في الواقع».
خل الدم الغالي يسيل
إن المُسيل هو القتيل
هذا أنا أسميه الدم الغالي. وفي الحقيقة هناك دم رخيص مع الأسف. وفي العراق جرى كثير من هذا الدم المرتجل، غير المستهدف، أو المستهدف المنحرف، أي غير المصوَّب، وغير الرامي إلى هدف محدد. فهذا مع الأسف يسمونه الدم الهدر. هذا شيء، والدم الغالي شيء آخر؛ الدم الغالي المصمم الثائر، والمثمر أيضاً؛ لأن هناك دماء رخيصة سالت كثيراً دون أن تُثمر شيئاً.
وحين سألته: وهل أثمر الدم في العراق يا أستاذ؟ أجاب: «مع الأسف وبصراحة لم يُثمر كثيراً، الدم درس، الدم عبرة وعظة. وما نحن فيه اليوم بعد هذا كله وبعد الدماء التي سالت في الواقع، مع الأسف ليست تكافئ النتائج أو المواقف الراهنة، أو قبل الراهنة، أو في كل المراحل التي مرَّ بها التاريخ العراقي. كان الدم في العهد الملكي كثيراً ما يُهدر.
فمعاهدة بورتسموث أُلغيت ببيان رسمي، بموقف شريف لا أشرف منه، حتى من قبل الملكية. أُذيع البيان في الليلة الشهيرة وأُسقطت المعاهدة نزولاً عند آراء قادة الأحزاب وزعماء البلد، ورغبة الشعب اعتُبرت لاغية ببيان رسمي. ونُفاجأ في الصباح بمعركة الجسر وذهب فيها جعفر شهيداً رخيص الدم في الواقع. فهو دم غالٍ من جهة، ومهدور من جهة أخرى. فأنا لم أفهم -مثلاً- لماذا أُلغيت المعاهدة؟ فكان الدم يسيل لشيء آخر، ويُدخّر لمرحلة قادمة ولمطلب جديد، لا لمعاهدة أُسقطت بحد ذاتها وانتهى كل شيء.
فالدم عندي في الواقع مصدره ومنطلقه الحرص على الدم وليس الاستهانة به».
الصِّدام مع عبد الكريم قاسم
مع ترحيب الجواهري بانقلاب عبد الكريم قاسم على الملك فيصل الثاني سنة 1958، إلا أنه لم يستمر مع صديقه القديم الذي تعرَّف عليه في لندن، وذهب به إلى عيادة الأسنان متكفلاً بعلاج ما كان يشكو منه، وذلك حينما كان قاسم ملحقاً عسكرياً هناك. فقد ثار الجواهري على تقييد الزعيم حرية الصحافة، وهو من تمتع بها في إصداراته الصحفية -«الرأي العام» خاصة- التي استمرت في الصدور منذ 1941 حتى 1961، السنة التي غادر فيها العراق، بسبب احتكاكه المباشر مع قاسم، مغترباً في براغ سعيداً بلجوئه السياسي إليها.
في هذه المدينة الجميلة بطبيعتها والمتعددة في مقاهيها المأنوسة، رقَّ طبع الجواهري، بعد صحراوية النجف وطبيعتها الجافة، وأشرقت صوره بكل ما في تشيكوسلوفاكيا من خضرة أرض وجمال صبايا. يقول في قصيدته «بائعة السمك»:
ذاتَ غداةٍ وقد أوجفتْ
بنا شهوةُ الجائعِ الحائرِ
دَلَفنا لِـ«حانوتِ» سمَّاكةٍ
نُزَوَّدُ بالسمكِ «الكابري»
فلاحتْ لنا حلوةُ المُجتلى
تَلَفَّتُ كالرشأ النافر
تَشُدُّ الحِزامَ على بانةٍ
وتفْتَرُّ عن قمرٍ زاهر
ومع ذلك، فإن الحنين إلى العراق وهو في العراق، دائماً ما يشده إليه، بل يكدره اشتياقه إليه، وقد أصبح في منفاه الناعم في براغ، مستذكراً على الدوام ما قاله في «مقصورته» الطويلة عن حنينه الوطني الراسخ، وهي إحدى أبرز مفاخر الجواهري الشعرية. نظمها في أواسط عام 1947، ونشر قطعاً منها في جريدته «الرأي العام».
وقد ذكر شرَّاح الطبعة التي أصدرتها وزارة الثقافة العراقية، من مجموعته الشعرية ذات الأجزاء السبعة سنة 1974: «إن جزءاً كبيراً منها يزيد على مائة بيت قد أطارته الريح وألقته في دجلة في أثناء اشتغال الشاعر بتنقيحها خلال صيف عام 1974، حيث كان يسكن داراً مطلة على النهر».
سلامٌ على هَضَباتِ العراقِ
وشطَّيهِ والجُرْفِ والمُنحنى
على النَّخْلِ ذي السَّعَفاتِ الطوالِ
على سيّدِ الشَّجَرِ المُقتنى
ودجلةَ إذْ فارَ آذيُّها
كما حُمَّ ذو حَرَدٍ فاغتلى
ودجلةَ زهوِ الصَّبايا الملاحِ
تَخَوَّضُ منها بماءٍ صَرى
تُريكَ العراقيَّ في الحالتينِ
يُسرِفُ في شُحّهِ والنَّدى
في بيت الجواهري بدمشق
بعدما انتهت المقابلة التلفزيونية التي استمرت زهاء الساعتين مع الشاعر الكبير الجواهري، دارت حول سيرته الذاتية الصاخبة بأحداث العراق ومواقفه المتقلبة منها. نادى على ابنته «خيال» لكي تقوم بواجب الضيافة… «الرقي» البطيخ الأحمر الذي يذكِّره بطعم السنين الخوالي في العراق، و«الشمام» البطيخ الأصفر الذي يتذوق معه حلاوة الطبيعة الشامية.
قال لي: «كُلْ من هذا الشمام… إنه لذيذ جدّاً، حتى إن أهل دمشق يسمونه أناناس!» قلت: يا أبا فرات… أين الشاي؟ إنني بعد هذه الجولة المثيرة في سرد تاريخك الشخصي المتلاحم بتاريخ العراق الحديث، لا بد لي من رشفات شاي عراقي أصيل (سنجين) أحبّذ دوماً تناوله في «استكانة»!
توقف برهةً ليسألني: «هل لك صلة قربى بالعراق؟ إنني أعرف عائلة مرموقة المكانة تُدعى عائلة القطيفي، منها من دخل عالم الصحافة والسياسة والوزارة». أجبته: توجد صلة صداقة، أما العائلة التي تشير إليها في القطيف، فكأنك تشير إلى أحد أبنائها وهو الدكتور عبدالحسين القطيفي، من أوائل خريجي السوربون في العهد الملكي العراقي، الذي استثمر عبد الكريم قاسم تخصصه في القانون الدولي، فعيّنه وكيلاً فاعلاً لوزارة الخارجية، ليمثل العراق الجمهوري في مفاوضاته مع دولة الكويت بعد استقلالها.
أما الوجه القطيفي الآخر في العراق فهو سلمان الصفواني القطيفي، الذي التحق بحركة الإمام الخالصي لنيل استقلال العراق التام من الهيمنة البريطانية على قراره الوطني. وبعد ذلك عرفه العراقيون صحفيّاً بارزاً، شُهر بمقالاته ذات النغمة العروبية. هذا ما ذكره الأستاذ عبد الرزاق الهلالي، مؤلف كتاب «زكي مبارك في العراق»، مشيراً إلى تلاحي الصفواني الأدبي مع الأديب المصري د. زكي مبارك، في أثناء انتدابه للتدريس في دار المعلمين العالية ببغداد، بين سنوات الثلاثينات والأربعينات، حين كان يساجل الصفواني على صفحات مجلته (اليقظة) البغدادية. هذا وقد أصبح الصفواني فيما بعد وزيراً في حكومة العارفين، وزيراً لشؤون مجلس الوزراء مرتين، مكافأة لعداوته الضَّروس لنظام عبد الكريم قاسم، بعدما هرب منه بداية الستينات إلى خارج العراق، فاختار القاهرة مهاجراً ومستقرّاً.
قال الجواهري: «دعْكَ من هذا الآن… وعليك بأكل البطيخ الأحمر والأصفر، وشرب القهوة المرة. ولنجعل شرب الشاي العراقي تحيةً لهذه السهرة على أن تأتيني من غد… فإنَّ لي معك حديثاً قد يطول».
في ضحى اليوم التالي توجهت إلى دارته، وهي عامرة بالحراس والسيارة المرسيدس الفارهة، وحين أذن لي، استقبلني بحيوية فائقة. كان قد حلق ذقنه! أمسك بيدي ليقودني إلى مجلس صغير اختاره للاختصار بي.
من فوره انطلق يُبدي رغبةً شديدةً في زيارة المملكة، معبِّراً عن أنها تلحّ عليه منذ قابلَ نائب الملك فيصل في زيارته لبغداد في سنوات الثلاثينات الميلادية، ونظم فيه قصيدة نكايةً بالملك فيصل الأول في موجةٍ من تقلباته العارمة. وأردف: «لعلك قرأت قصيدتي في مدحه، حيث طلبت منه نشرها في جريدة (أم القرى). بل إنني أبديت رغبتي في أن يوصل إلى والده الملك العظيم عبد العزيز بن سعود أن أكون ضيفاً عليه في السعودية».
أجبته: يا أبا فرات تلك كانت مناورة سياسية منك. فبقصد تصعيد خلافك مع ملك العراق فيصل الأول، رحت توغر صدره بمديح فيصل السعودية ووالده الملك عبد العزيز.
انفرج وجهه عن ابتسامة ماكرة قائلاً: «هذا صحيح… ولكن مدحي لعبد العزيز كان محض إعجاب شخصي بفروسيته العربية… واليوم وأنتم أيها السعوديون تتمتعون بما قام به الملك عبد العزيز من دولة أصبح يُحسب لها ألف حساب، لماذا لا تساعدني على تلبية رغبة يمتد عمرها إلى أكثر من ستين عاماً بزيارة بلادكم؟ إنني أسمع عن مهرجان الجنادرية».
أجبته: بلادي مفتوحة لزيارة أي مفكر وأديب وشاعر عربي… فما بالك بشاعر شهير، يحمل على ظهره هذا السجل السياسي والثقافي الحافل للعراق في القرن العشرين، منذ ثورة العشرين! إن الجميع سيرحبون بك من القمة إلى القاعدة.
وهنا وجدته يخط بيده المرتجفة إهداءً معبراً على ديوانه كاتباً النص التالي: «إلى أخي وحبيبي الكريم… أهديه إليك، ومعه فرط حبي وحميم إعزازي. المحب المعهود محمد مهدي الجواهري 21 تموز 1994م».
بعد هذا التاريخ بأقل من عام، قام الجواهري بزيارته التاريخية للمملكة، ليشهد فعاليات مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة. وما انتهى أمر الزيارة إلا بغضب الإعلام العراقي عليه، وقد استفزته زيارة الجواهري للمملكة والاحتفاء الرسمي والأهلي به، مما أدى إلى نزع الجنسية العراقية من أكبر رمز يلتقي عنده وعليه العراقيون بمختلف أطيافهم ومشاربهم!
العجيب أنه قبل أن يطلق الإعلام العراقي النار الإعلامية على الجواهري، كنت دائماً ما أسمعه يردد بينه وبين نفسه، عند زيارته معالم الرياض أبياتاً من شعره -وقد كنت مرافقاً له- أما حينما وقف على صحراء نجد، فإنه تذكر على الفور امتدادها الصحراوي إلى الكوفة والنجف، فطفق يتشوق إلى الأماكن القديمة في زمن طفولته وصباه، مخاطباً وطنه:
حييتُ سفحك عن بُعدٍ فحيِّيني
يا دجلةَ الخيرِ يا أمَّ البساتين
المصدر : وكالات